ترجمة علي كامل
هل تستحق أمريكا البقاء على قيد الحياة؟ إنه السؤال المثير الذي طرحه وليم فوكنر علناً عام ١٩٥٥ حين وصلته أنباء تفيد أن مواطنه إيميت تيل، وهو شاب أسود يبلغ من العمر ١٤ عاماً، تم قتله وتشويهه في ولاية ميسيسيبي لأنه تجرأ أن يصفر بفمه في زواج إمرأة بيضاء. هذه الحادثة التي هي بمثابة حالة إعدام خارج نطاق القانون، والتي كانت حافزاً لإنشاء حركة الحقوق المدنية المسماة «ماتر». السؤال ذاته تكرر طرحه ثانية وبصوت جهوري في الفترة التي رشّح دونالد ترمب نفسه لرئاسة الولايات المتحدة ومن ثم فوزه بالرئاسة من بعد.
لم يكن هذا السؤال هو ما كنت آمل إثارته ثانية في هذه الزيارة الأدبية المقدسة التي قمت بها أنا وزوجتي إلى مدينة أكسفورد في ولاية مسيسيبي هناك حيث عاش فوكنر معظم حياته وحيث كتب الروائع الغزيرة التي جعلته الروائي الأميركي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين.
لقد كنا نخطط لمثل هذه الرحلة منذ سنوات عديدة وقد اعتبرناها فرصة مناسبة للتأمل في وجود ومخيّلة مؤلف كان قد حفزني في مراهقتي التشيلية على التخلي عن السرد التقليدي والمخاطرة في كل شيء بوصفه السبيل الوحيد لتمثل التدفق المزدوج المرّكب أو المتعدد للزمن والوجدان والمأساة. فوكنر الذي حثني على محاولة التعبير عمّا يعنيه أن أكون حياً وأن أعرف بعمق جنوبيَ التشيلي الأكثر نأياً وفقداناً من جنوب فوكنر التعيس. ومع ذلك، فإن السؤال حول حق بقاء الولايات المتحدة على قيد الحياة هو السؤال الذي حاصرني حين قمنا بزيارة القبر الذي يرقد فيه منذ ٥٤ عاماً جسد هذا الكاتب والانسان العظيم، السؤال الذي انبثق أمامي حين كنا نقطع الشوارع التي سار فيها، وهو السؤال الذي لا أستطيع تجنبه وأنا أسير عبر روان أوك، القصر الذي كان بالنسبة له هو البيت الأكثر ديمومة.
لو أن مؤلف كتاب «الصخب والعنف» كان حياً اليوم ليشهد وضع بلاده وهي تواجه الخيار الأكثر حسماً لعصرنا المضطرب، حيث يتوق ديماغوغي شيطاني، على نحو غير عادي، إلى احتلال البيت الأبيض، وهو ما يعني دون شك أن ثمة «لحظة مبهمة من الإرهاب» تقترح طرح سؤال فوكنر المؤلم ثانية بوجه ترامب وأتباعه، مثل العديد من شخصياته الروائية، في نبذ سياسة الكراهية وأن لا يحكموا على أنفسهم وأرضهم التي يحبونها بالهلاك بدافع الغضب والإحباط والخضوع لظلمات وفضاضة الماضي الجامح الذي ورثوه.
لن تكن كلمات فوكنر اليوم موجهة إلى الأمريكيين من أصل أفريقي على الرغم من أنه كتب عن معضلتهم بحساسية ملحوظة واصفاً كيف أن أحفاد العبيد قد حملوا «بفخر صارم وغير مرن» العبء المفروض عليهم من قِبل نظام متآكل وغير عادل. الرجل الذي وجّه النصح لهم بالتحلي بالصبر كوسيلة للتغلب على الحواجز العرقية، الرجل الذي لم يسمع خطابات مارتن لوثر كينغ في واشنطن، الرجل الذي لم يكن يعتقد حتى بإمكانية وجود رئيس ولد من تمازج الأجناس أو ولادة حركة الحياة السوداء (دون الحاجة لذكر أوبرا وينفري)، الرجل الذي لم يكن يعرف أن أمريكا هذه أصبحت بلداً متعدد الثقافات مزدحم بالمهاجرين الجدد، وبنفس القدر كان سيصعب عليه أن يفهم أن نساء القرن الحادي والعشرين استطعن تحقيق حريتهن واكتفائهن الذاتي وحصلن على سلطات واسعة عن طريق الثورات النسوية التي لم يكن يتوقعها. غير أن الجوانب الأخرى التي لا تحسد عليها أمريكا المعاصرة، ستكون، مع ذلك، مألوفة أكثر لفوكنر للأسف الشديد.
سيصيبه الذعر حقاً، إن لم يكن الاستغراب، لمرأى شخصية خطيرة مثل دونالد ترامب وصعوده إلى السلطة أو الخطر الجنوني الذي يمثله.
لقد ابتكر فوكنر في عالمه التخييلي الشاسع والمدّمر تجسيداً جنوبياً لشخصية ترامب وإن كان على نطاق ضيق: إنه فليم سنوبس، المفترس المتطفل الشره وعديم الضمير ذو العيون التي «بلون المياه الراكدة»، والذي ارتقى إلى السلطة عبر الأكاذيب والمكر والترهيب والغش والاحتيال على أي أحمق أو ساذج يظن أن بوسعه أن يكون أكثر فطنة منه.
لقد فضح فوكنر، عبر شخصية فليم وقبيلته، العديد من مواطنيه الذين «لا يعرفون ولا يؤمنون بأي شيء غير المال، دون أن يأبهوا كثيراً بكيفية الحصول عليه». ولم يكن لديه أي شك حول الضرر الذي يمكن أن يلحق بالناس لو سُمح لمثل عشيرته بالانتشار والتناسل، أو لو أن «مخادعهم التافه وفاسدهم الصغير الذي كان يسعى من أجل غايات صغيرة وتافهة» يمكن أن يسود ويروج سوقه. غير إن مجرد كون ترامب، هذا الكائن المَرَضي وغير الأخلاقي، الذي لا يستحق أن يكون حتى مرشحاً مقبولاً، أصبح رئيساً للولايات المتحدة، وهذا وحده سيكون أمراً مرعباً ومثيراً للاشمئزاز لفوكنر.
على الرغم من التحرر والتقدم السياسي لزمن فوكنر، إلا إن موقفه إزاء تابعي ترامب سيكون أمراً مختلفاً. إنه هو من صّور بمحبة وحنان، وغالباً بمرح، حياة أولئك الذين يتماهون بهؤلاء الذين نتحدث عنهم اليوم، مؤيدي ترامب الأساسيين، الصيادين ومالكي السلاح، الذكور المضللين غير المستنيرين، المتشبثين بفحولتهم المُهدِّدة، الأمريكيين البيض الذين يعيشون في الأرياف الصغيرة، يعانون الضيق الاقتصادي وينوئون تحت وطأة قسوة إندفاع الحداثة غير مهيئين لعولمة هم غير قادرين على التحكم بها.
ورغم عدم تغاضي تلك الشخصيات الفوكنرية عن تحيزاتها العنصرية وجنون الإضطهاد، لكن المؤلف العبقري لم يتخل عنهم مطلقاً ولم يكن ينظر إلى حيرتهم وسذاجتهم باستصغار وازدراء، بل كان يمنحهم دائماً الشيء الوحيد الذي يتوقون إليه بشدة ومازالوا يتوقون إليه الآن، وهو إحترام كرامتهم الإنسانية.
لقد كان فوكنر يدرك جيداً جذور السخط والاستياء الحالي لأولئك الذين كان يكترث بهم كثيراً، وكان يعرف الخوف الذي يُستمد منه ذلك السخط، الشعور بأنهم حوصروا في مد تأريخي هو ليس من صنع أيديهم، بل هو حلمهم الأمريكي الذي تمّلكه الغضب والجنون. وهذا هو ما يجعل صوت فوكنر ثمين جداً اليوم.
إن التعاطف الذي عبّر عنه هذا الروائي الاستثنائي المتقدم على عصره والذي كان يشعر بالشفقة على الناس الأقل تعليماً وثقافة والمحافظين دينياً، أولئك المقيمين في إقليمه الخيالي «يوكناباتوفا»، وإحساسهم بالخسارة والضياع، وحقيقة أنه آثر رفقتهم ومشاركتهم الآمنة والدائمة على المثقفين المتميزين والصفوة التجريديين ما جعله ملائماً، بطريقة مثالية، لإيصال خطاب أن على أنصار ترامب ومحبيه محاولة الاستجابة لنداء الوقوف ضد التعصب الأعمى والخوف والتفرقة الذي لا تشوبه، ولو بتلميح، فكرة التسلط أو الوصاية.
وفيما أنا أفكر بمنضدته الهشة والصغيرة في مكتبه في روان أوك، هناك حيث دوّن كلمات موجزة لمناسبة تخّرج ابنته «جِل» من الثانوية والتي يمكنني سماع صداها اليوم وأنا فخور أن أنقلها مرة ومرات إلى مواطني فوكنر في وقتنا الراهن. لقد كان يحث صّف ابنته المدرسي ويحثنا الآن، أن نصبح أشبه بـ «الرجال والنساء الذين يرفضون دائماً أن يُخدعوا أو يخافوا أو يُرتشوا عبر الامتثال أو الاستسلام».
هذا ما قاله لهم ويقوله لنا مرة أخرى ومرات بأن لدينا ليس الحق فحسب، «إنما الواجب أيضاً، أن نختار بين... الشجاعة والجبن...».
إنه يتحدث إليّ ولهم وإلى كل واحد منا مطالباً إيانا بأن «لا تخافوا من رفع أصواتكم عالياً من أجل الصدق والحقيقة والشفقة، ضد الظلم والكذب والجشع».
هل سنتعثر ونترنح نحو الهاوية ونؤول إلى الحزن والأسى؟
هل نحن محكومون بالمأساة مثل الكثير من شخصيات فوكنر العنيدة والقاسية، أم لا تزال لدينا الفرصة والحكمة لإثبات أن هذا البلد يستحق البقاء على قيد الحياة؟










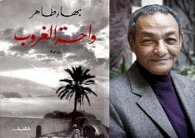









التعليقات