النظم السياسية العاقلة لا تجد أي ميزة في العيش في بيئة إقليمية مشوبة بالتوتر والقلق وبواعث النزاعات والصراعات الباردة أو الساخنة. بعض هذه النظم يبذل شيئاً من موارده وجهده ووقته، وأحياناً من مصالحه الثانوية، في سبيل تنقية هذه البيئة وتصفية المشكلات أو تصفيرها من حول دولته، وربما ساقته الحكمة والنظرة الاستراتيجية المعمقة للمصالح الوطنية، إلى البذل والعطاء بالأريحية ذاتها، لأجل المساهمة الفاعلة في إقرار السلم والأمن على الصعيد العالمي.
في رحاب «الشرق الأوسط»، يبدو السلوك الإقليمي لنخبة الحكم والسياسة في إسرائيل، مجافياً كلياً لهذا التقليد الرشيد. كل النخب التي تقلبت هناك على سدة الحكم، أضاعت فرصاً ثمينة ومبادرات حميدة، كان التجاوب معها، ولعله مازال كفيلاً بتخليصها من عبء القضية الفلسطينية، التي تتفاعل سلبياتها داخل أحشاء الدولة، وكذا في جوارها الإقليمي، وذلك إلى الحد الذي جعل منها دولة تنام بنصف عين، تتوجس خيفة وتحسب كل صيحة عليها وتتأبط السلاح على مدار الساعة، وتقترف مخالفات تعز عن الحصر بحق الشرائع والقوانين والأعراف، التي سنتها وتوافقت عليها الأمم المتحضرة.
الاستنفار الأمني الدائم بين الإسرائيليين، وحساسيتهم المفرطة تجاه أي معطيات أو متغيرات إقليمية، يرونها غير مواتية لمفهومهم الواسع جداً لأمن دولتهم، وأحياناً لمصيرها برمته، هي حقائق تتصل في أصلها بسياستهم المنحرفة قانونياً وأخلاقياً تجاه القضية الفلسطينية، وهم يدركون أن كلمة السر في تهيئة أجواء تضمن تحقيق هذا الأمن، تتعلق بتسوية هذه القضية وإغلاق ملفها، لكنهم بدلاً من تبني هذه الكلمة والانصياع لاستحقاقاتها، يتعاملون فقط، ووفقاً لتكييفاتهم ورؤاهم دون غيرها، مع أعراض القضية وتداعياتها.
في إطار هذه المعالجة غير السوية، يدافع النظام الإسرائيلي عما لا يمكن لدولة رشيدة أن تدافع عنه، لا في نطاق الشرق الأوسط ولا في أي نطاق إقليمي، ألا وهو ديمومة السيطرة الحديدية على شعب آخر، معترف له بالحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة من مائة وأربعين دولة.
إذا مددنا خطوط التحليل على استقامتها، تأكدنا أكثر فأكثر من كون هذه المقاربة المعيبة كفيلة بإقلاق راحة الأمن الإقليمي، إن لم يكن انتهاكه تماماً، هذا أمر يمكن تفهمه في سياق منطق الفعل ورد الفعل. فمنظور الإسرائيليين الاستثنائي في أنانيته للأمن، الذي يعتقد بعضهم أنه يتعلق بالمساحة ما بين كراتشي والدار البيضاء، مؤداه بشكل مباشر أو غير مباشر إلحاق أضرار بأمن معظم دول الجوار.
بصيغة أخرى، لا تراعي إسرائيل، وهي تقارب مفهومها المطاط للأمن، القاعدة التي تفترض أن أمنها الأقليمي ينتهي عند حدود أمن الآخرين. أحد أمثلة هذا التجاوز تتجلى راهناً في رؤى قطاع من منظري السياسة والأمن المتنفذين، التي تعتقد بأن أمن إسرائيل واستقرارها، يمكن أن يتعزز إلى أفق تاريخي مفتوح، عبر حراكات وضغوط عسكرية وغير عسكرية متضافرة، تجبر فلسطينيي غزة والضفة والقدس على الهجرة أو المغادرة طوعاً أو قسراً.
لا ريب أن تفكيراً من هذا القبيل يناقض جذرياً شروط الأمن وموجباته في الشرق الأوسط.. وهو ينطوي يقيناً على مستقبل سوداوي لأمن الشعب الفلسطيني ومصيره، علاوة على معانيه ومغازيه المقبضة بالنسبة لأمن واستقرار دولتين إقليميتين موادعتين لإسرائيل سلمياً، مصر والأردن.
ولا يقل عن ذلك إيغالاً في محاولة إدخال الإقليم في نفق مظلم، التحريض الذي تضطلع به تل أبيب، لأجل ترقية مناوشاتها واصطكاكاتها مع نظام طهران، إلى مستوى يكره حلفاءها ومحازبيها الغربيين، الولايات المتحدة بالذات، على التخلي عن حساباتهم الخاصة والصدام المسلح مع هذا النظام.
لزهاء العقدين من ولايتهم في الحكم لم يمل نتانياهو، وبطانته الموصوفة بالتطرف، من السير على هذا الطريق. لقد عكفوا على ذلك وألحوا بقوة في عهود بوش الابن وأوباما وترامب. ومن حسن الطالع أن واحدة من هذه الإدارات، لم يبلغ بها الانحياز لإسرائيل، حد التجاوب مع نداء طبول الحرب التي تدقها هذه الجوقة.
والظاهر حتى اللحظة، أن إدارة بايدن، المنشغلة داخلياً بموسم انتخابات رئاسية صعبة، والمنغمسة خارجياً في تعقيدات أكثر من معترك وميدان، ليست بدورها بوارد الانصراف عن هذا النهج.. وأنها ترى أن مصالحها تتطلب ضبط إيقاع الاشتباك الإسرائيلي الإيراني، بمقتضى حيثية «رمزية» لا تورطها في حرب يمكن معرفة بدايتها، بينما لا يمكن بالمطلق الوقوف على تطورات حدودها وسقوفها الإقليمية، وربما العالمية أيضاً.







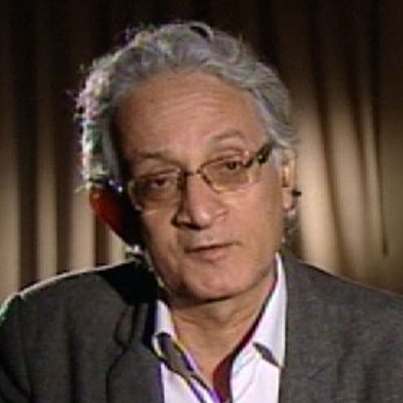













التعليقات